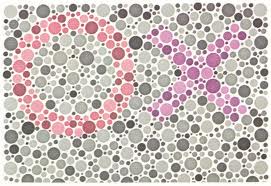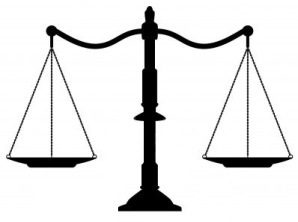إجتمعت أنا ومجموعة من أطفال العائلة لنلعب اللعبة المعروفة التي بدأت كتسلية عائلية، لتتحول لاحقاً إلى مسابقات تلفزيونية يشارك فيها الفنانون والمشاهير في إختبار لقدراتهم التمثيلية حين يحرمون من إستخدام نعمة الكلام.. يحاولون أثنائها إيصال العبارة الموكلة إليهم للجمهور بإستخدام لغة الإشارة وحسب. لعبة مسلية وملهمة، تفجر المواهب وتخرج الكوامن لكل من يشارك فيها…
إلا أن ما حصل لي أثناء مشاركة إحدى المتسابقات الصغار تركني فاغراً فمي…
هي طفلة في قرابة العاشرة من عمرها، أبدعت في كل محاولاتها في تمثيل العبارات التي أعطيناها إياها، حتى جاء دوري في إعطائها التحدي التالي الذي لم أدر أنه سيفجر ما في داخلها… فكرت ملياً في عبارة يعرفها كل الأطفال المتجمهرون، ثم ناديتها لأهمس العبارة في أذنها، والتي هي عنوان لإحدى أغنيات فرقة “طيور الجنة” التي أدمن سماعها الأطفال…
طَلبت الفتاة من الجمهور الصمت لتركز أفكارها ولتستعد بتقديم العبارة بأفضل طريقة ممكنة… ثم بدأت لتتعالى معها أصواتهم الصغيرة بالمشاركات الحماسية..
“الكلمة الأولى… لا؟! طيب بلاش… الكلمة الثالثة…. ممم… بطيخة؟! …. طيب كرة؟؟!! عرفت عرفت… بالوووون!”
“صححححححح!” قفزت في فرح لنجاحها في إيصال الكلمة، ثم أشارت إلى سبابتها التي أرتفعت مع أصابعها الثلاث لتعلمهم أنها ستعود لتمثل الكلمة الأولى…
وقفت حائرة لبرهة تنظر حولها… ثم رفعت نفسها على أطراف أصابعها في إستعلاء… وعصرت كتفيها للأعلى لتمثل دور القوة… وقطبت حاجبيها في غضب، وأنطلقت تسير بسرعة وهي تتمتم بصمت بشفتيها موبخة الجمهور… وباطشة بيديها يمنة ويسرة، وكأنما تلحق بهارب لتلقنه درساً لن ينساه بـ “كف” أو “لكمة” أو “تهزيئة” على أقل تقدير…
انفجر الجمهور بالضحك مما اضطرها للإستسلام وإعطائهم الإجابة… “إشبكم ما عرفتوا، والله سهلة مررررة… العبارة هي: بابا جابلي بالون!”
سكتُ أنا لبرهة أتأمل فيها الطريقة التي مثلت فيها كلمة “بابا”… البطش والضرب المبرح والكلمات الجارحة!
ثم أدركت أن “بابا” المخزن في ذاكرتها والذي حاولت إيصال صورته لنا لم يكن هو نفس الـ “بابا” المخزن عند بقية الأطفال، مما تركهم في حيرة من أمرهم، فلم يجدوا جواباً شافياً غير الضحك…
تأملت ذلك الموقف في صمت لأكتشف أنه أبعد ما يكون إلى الضحك!
و تفكرت فيما لو أنني طلبت من بقية الأطفال تمثيل كلمة “بابا” أو “ماما” فما النتيجة؟ ماذا لو طلبنا من بالغين عاقلين من النساء أو الرجال تمثيل كلمات مثل: “الحياة” أو “الحب” أو “الزواج” أو “العمل”؟! يا ترى ماذا ستكون النتائج؟
يقال أن 70% مما نحاول قوله يتجلى في لغة الجسد، أما الـ 30% الباقية فتخرج على هيئة كلمات في أحيان كثيرة تكون بعيدة كل البعد عما نكن في دواخلنا… لست متأكداً من صحة العبارة السابقة ولا أذكر أين قرأتها، إلا أن الموقف الذي ذكرته سابقاً أكدها لي…
في حوار أخوي مع صديقي المدرب بدر يماني حول أحد الدعاة واسلوبه في طرح المعلومة، طلب مني أن أشاهد المقاطع اليوتيوبية لذلك الداع على الصامت … “إن أردت أن تعرف ما يقصده بصدق، فراقب قسمات وجهه وحركات شفتيه ويديه، ثم أخبرني عن الأحساس الذي سيصلك حينها!”… فعلت ذلك لأكتشف تناقضات بين كلامه وحركاته في بعض الأحيان…
تذكرت بعدها مقولة لسيدنا علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه يقول فيها: “ما أضمر امرئ أمراً إلا وأظهره الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه”
حقيقة علينا إدراكها… فالقناعات التي نحملها معنا في دواخلنا ما هي إلا مرآتنا التي تعكس نظرتنا عن الحياة… كما يقول أحد العارفين: “أنت لا ترى الحياة كما هي، إنما تراها كما تكون أنت!”
يا ترى لو طلب من أحدنا أن يقف ليمثل ما تعنيه له الحياة “بدون كلام” فما “الكلام” الذي سيخرج منه؟
دمتم بحب
تابعني هنا – Follow me here